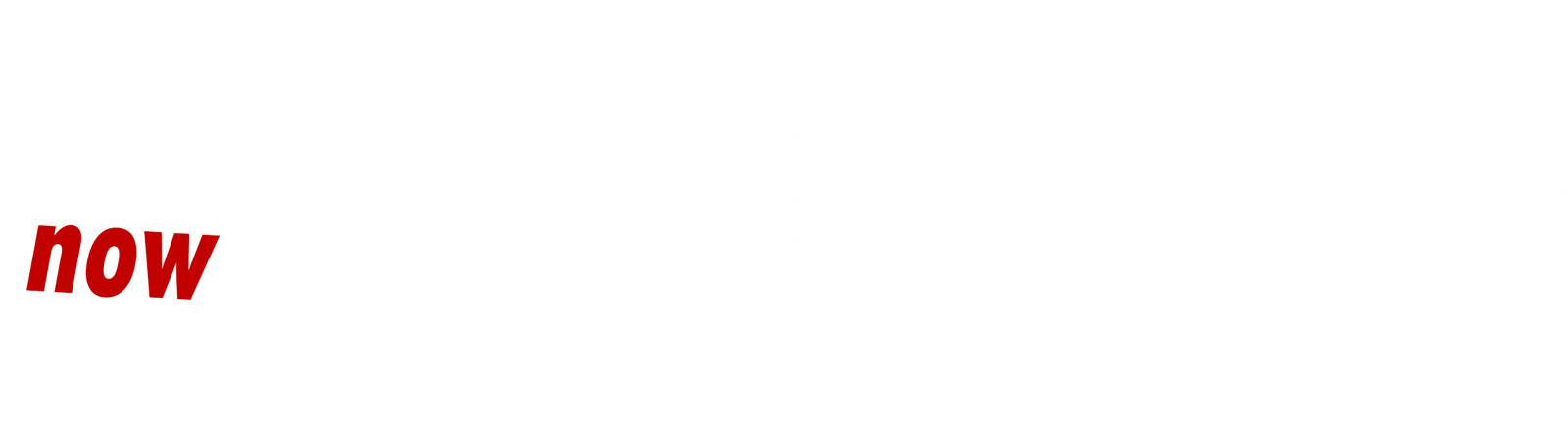على امتداد ما يقارب العقد الذي أعقب عملية عاصفة الحزم عام 2015 في اليمن، بدا وكأن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تشكّلان ركيزتين متلازمتين لمشروع إقليمي واحد يتقدّم بثبات، حيث تلاقت سياساتهما تجاه إيران وأذرعها ضمن مقاربة ردع متدرّجة، وتداخل حضورهما العسكري والأمني في اليمن ضمن غرفة عمليات شبه موحّدة؛ كما تقاطعت خياراتهما في التعامل مع موجات الانتفاضات العربية عبر دعم قوى سياسية وأمنية متقاربة التوجّه (في سورية وليبيا والسودان). بلغ التنسيق ذروته في الإجراءات الجماعية التي فُرضت على قطر بعد حصار عام 2017، الأمر الذي أُوِّل بوصفه تجسيدًا لتحالف قيادي جديد يقوده محمد بن سلمان ومحمد بن زايد ويعيد ترتيب المجال الخليجي بعد مرحلة التشتت التي أعقبت الربيع العربي. غير أن هذه الشراكة حملت في داخلها تناقضًا بنيويًا ظلّ مستترًا ما دامت البيئة الإقليمية محكومة بمنطق الطوارئ والأزمات، إذ حافظ الخطر الخارجي المشترك على تماسكها، بينما أخذ التباين يتكشّف تدريجيًا مع انتقال الدولتين من إدارة التهديدات إلى إدارة الطموحات، أي من جيوسياسة البقاء إلى جيوسياسة بناء الدولة وتعظيم المكانة، فتحوّل التنسيق تدريجيًا إلى تنافس يتسع نطاقه عامًا بعد عام.
وجاءت اللحظة الفاصلة حين شرعت الحكومتان بالتوازي في السعي إلى احتلال موقع الدولة المحورية في الشرق الأوسط، فالإمارات كانت قد أرست منذ تسعينيات القرن الماضي نموذجها القائم على اقتصاد الموانئ والخدمات المالية والطيران وسلاسل الإمداد العابرة للحدود والخدمات اللوجستية، بما حوّل دبي وأبوظبي إلى عقدة اتصال بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، بينما أطلقت السعودية عبر رؤية 2030 مشروعًا واسعًا لإعادة هندسة اقتصادها وتحويله من اقتصاد ريعي يعتمد على الطاقة إلى اقتصاد مركزي يستقطب الشركات العالمية ويعيد توجيه حركة الاستثمار الإقليمي نحوه. عند هذه النقطة فقدت العلاقة طابع التكامل واكتسبت طابع المزاحمة المباشرة، إذ أصبح انتقال المقرات الإقليمية للشركات إلى الرياض يعيد توزيع ثقل الأعمال بعيدًا عن دبي، كما أن توسّع الاستثمارات الإماراتية في موانئ البحر الأحمر والقرن الأفريقي أعاد رسم مسارات التجارة البحرية بطريقة حدّت من قدرة السعودية على احتكار موقعها كممر رئيسي للطاقة والتجارة. وهكذا تبلور الخلاف بوصفه تنافسًا هيكليًا حول تنظيم الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة، حيث يدور جوهره حول الجهة التي تضبط شبكات الربط الإقليمي وتحدد اتجاه تدفّق المال والبضائع والبيانات، أي حول من يمتلك وظيفة المركز في النظام الشرق أوسطي الجديد.
نموذج حرب باردة
تستهدف عملية التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية إعادة تعريف موقعها داخل الاقتصاد الإقليمي بحيث تغدو بوابة إلزامية للأسواق العربية، بعدما ارتبط حضورها لعقود طويلة بدور المورّد الرئيس للطاقة. هنا جاء قرار الرياض اشتراط نقل المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية إلى داخل المملكة من أجل الاستفادة من العقود الحكومية، كأداة تنظيمية تعيد تشكيل خريطة الأعمال في الخليج وتستقطب الثقل المؤسسي العالمي نحوها. يمكن قراءة هذا التوجّه بوصفه محاولة واعية لإعادة توجيه الجاذبية الاقتصادية من دبي إلى الرياض، أي تحويل مسار حركة الشركات والاستثمارات عبر سياسة تنظيمية مدروسة تعيد توزيع حركة المال والخدمات داخل المنطقة، خصوصًا في ظل التوترات الأخيرة التي دفعت عددًا من الشركات متعددة الجنسيات إلى إعداد خطط إدارة مخاطر بديلة تأخذ في الحسبان احتمالات تعطل سلاسل الإمداد أو تقييد الوصول إلى العقود الحكومية أو إعادة تنظيم التبادل التجاري بين الضفتين الخليجيتين.
اتخذت الاستجابة الإماراتية مسارًا توسعيًا خارجيًا يجنح إلى إعادة توزيع النفوذ بدل مجابهة السياسات السعودية بشكل مباشر، إذ كثّفت أبوظبي استثماراتها في الموانئ الممتدة من سواحل القرن الأفريقي إلى شرق المتوسط، وعززت شبكاتها المالية العابرة للقارات، وربطت حضورها التجاري بسلاسل إمداد دولية تربط أفريقيا بآسيا وأوروبا، بما يتيح لها الحفاظ على تدفق التجارة حتى في حال تعرض البيئة الخليجية لقيود تنظيمية أو توترات اقتصادية. ينعكس هذا على سلوك الشركات العالمية التي بدأت توازن بين مركز إداري داخل المملكة يضمن الوصول إلى السوق الحكومية الكبرى، ومركز تشغيلي في الإمارات يحافظ على مرونة الحركة المالية واللوجستية، الأمر الذي أبرز انقسامًا فعليًا داخل المنظومة الاقتصادية الإقليمية بين نموذج سعودي يقوم على مركزة النشاط داخل سوق قارية كبيرة تقودها دولة ذات ثقل ديمغرافي ومالي واسع، ونموذج إماراتي يقوم على توسيع الشبكات البحرية واللوجستية وتوزيعها جغرافيًا بحيث يرتكز النفوذ على تعددية النقاط لا على مركز واحد.
هنا يتولّد الاحتكاك في قطاعات متعددة تمتد من السياحة والطيران والمناطق الحرة إلى التمويل والبنية الرقمية والصناعات الترفيهية، إذ أصبح التخطيط المؤسسي العالمي يتعامل مع الخليج كساحتين اقتصاديتين متوازيتين أكثر منهما فضاءً موحدًا، في إشارة إلى انتقال المنافسة من مستوى السياسات إلى مستوى البنية الاقتصادية نفسها.
على مستوى آخر، يتجه التنافس بين الرياض وأبوظبي إلى التحول من ضغط اقتصادي متبادل إلى ما يشبه حربًا إعلامية وتجارية مكتملة الأبعاد تدور بين نموذجين مختلفين في تعريف الدور الإقليمي ذاته، حيث تتجاوز أدوات التأثير حدود الدبلوماسية لتدخل فضاء الصورة والرمزية الاقتصادية في آن واحد. فاشتراطات نقل المقرات الإقليمية وإعادة توجيه الاستثمارات والتنافس في قطاع الطيران والفعاليات الدولية لم تعد مجرد قرارات سوقية، بل تحولت إلى سرديات حول أي نموذج أقدر على قيادة المنطقة؛ فيها نموذج إماراتي يقوم على اقتصاد منفتح عالي الاندماج بالعالم، يقدّم نفسه كمنصة مالية وثقافية عابرة للحدود ومتوافقة مع شبكات التجارة والتكنولوجيا والتحالفات الجديدة، ونموذج سعودي يستند إلى ثقل جغرافي وبشري وديني وإعلامي واسع، ويعرض ذاته كمركز إقليمي كبير يملك قدرة التنظيم لا مجرد الوساطة، ويعيد تعريف السوق من كونه مساحة خدمات إلى كونه مجال نفوذ شامل.
أخذ هذا الصراع يتجسد في المجال الإعلامي بوضوح موازٍ للاقتصاد، إذ تتحول المعارض الدولية والأحداث الرياضية والترفيهية وشبكات البث والمنصات الرقمية إلى ساحات تنافس على سردية المستقبل في الشرق الأوسط، حيث تروّج أبوظبي لاقتصاد الحركة والمرونة والاتصال العالمي، بينما تعزز الرياض صورة المركز الثقيل القادر على استيعاب المنطقة ضمن مدار واحد. ومن هنا اكتسبت قرارات الشركات والفعاليات دلالة تتجاوز الربح والخسارة، فاختيار موقع الاستثمار أو المقر الإداري بات يحمل معنى الاصطفاف ضمن تصور معين لشكل الإقليم القادم.
ومع أي تصعيد إضافي يتجه هذا التنافس إلى إعادة رسم مسارات الحركة الاقتصادية والإعلامية معًا، عبر تحويل خطوط الشحن، وإعادة توزيع مراكز الطيران، وإعادة تشكيل البنية الرقمية ومنصات المحتوى، بحيث يغدو التحكم في تدفق المعلومات والسلع جزءًا من معركة واحدة. وبما أن اقتصاد الدولتين قائم على وظيفة الربط والعبور، فإن تغيير اتجاه التدفقات ينتج أثرًا مضاعفًا، فتأخذ فكرة الحصار هنا صيغة مختلفة تقوم على إعادة توجيه المسارات بدل إغلاقها، وعلى جذب الحركة نحو نموذج معين بدل منعها، لتصبح المنافسة صراعًا على من يحدد اتجاه المنطقة الثقافي والاقتصادي لا على من يعطله.
السيادة ونفوذ الممرات البحرية
تكشف التوترات الأخيرة التباين العميق في الرؤية الاستراتيجية بين الرياض وأبوظبي، إذ تنظر المملكة العربية السعودية إلى اليمن بوصفه امتدادًا مباشرًا لأمن حدودها واستقرارها الداخلي، وتسعى إلى قيام دولة موحّدة قادرة على ضبط المجال الحدودي ومنع تشكّل فراغات أمنية على خاصرتها الجنوبية، بينما تتعامل دولة الإمارات العربية المتحدة مع الجغرافيا اليمنية بوصفها سلسلة عقد ساحلية تتحكم بحركة الملاحة في باب المندب وتؤثر في طرق التجارة بين آسيا وأوروبا. ينعكس هذا الاختلاف على طبيعة التحالفات الميدانية، إذ دعمت الرياض الحكومة المركزية المعترف بها دوليًا وقواتها المرتبطة بها، في حين نسجت أبوظبي شبكة علاقات مع قوى محلية جنوبية وتشكيلات عسكرية متمركزة حول الموانئ والمضائق.
وقد أمكن لهذين النهجين أن يتعايشا مرحليًا تحت مظلة القتال ضد الحوثيين، إلا أن التوسع الميداني للقوى المرتبطة بالإمارات في المحافظات الجنوبية أعاد صياغة التوازنات، فانتقلت المواجهة من اختلاف في الأولويات إلى احتكاك مباشر حين استهدفت ضربات سعودية شحنات عسكرية مرتبطة بتلك الشبكات، في لحظة أظهرت هشاشة التوافق العسكري بين الحليفين. ومنذ ذلك الحين تحوّل اليمن من ساحة عمليات إلى اختبار لنموذج النظام الإقليمي نفسه؛ هل يُدار عبر دول مركزية تضبط حدودها أم عبر ممرات بحرية تديرها شبكات نفوذ موزّعة على السواحل.
مع تراجع حدّة المواجهة في اليمن امتد التنافس غربًا نحو القرن الأفريقي حيث تبرز أهمية سلاسل الإمداد أكثر من الاعتبارات الأيديولوجية، لا سيما وأن استثمارات الإمارات في موانئ مثل بربرة وبوصاصو أسست قوسًا بحريًا يربط المحيط الهندي بالمتوسط عبر بنية لوجستية وتجارية متشابكة، كما تقاطعت هذه الشبكات مع مسارات مالية تشمل تجارة الذهب وخطوط التجارة البرية الممتدة عبر السودان وليبيا نحو الساحل الأفريقي. في المقابل ترى السعودية، بالتقارب المتزايد مع مصر، أن انتشار مراكز ساحلية متعددة السلطات يضعف استقرار منظومة البحر الأحمر ويؤثر في الترتيب التجاري المرتبط بقناة السويس، إذ يعتمد أمن الطاقة السعودي وحركة الحج والزيارات الدينية والتجارة الدولية على بيئة بحرية مستقرة تخضع لإدارة دول مركزية واضحة.
وهكذا برز اختلاف في العقيدة الأمنية؛ حيث إن أبوظبي تدير نفوذها عبر فاعلين محليين (جماعات غير حكومية وميليشيات كما في السودان وليبيا وسورية) ومناطق اقتصادية شبه مستقلة، بينما تفضّل الرياض دعم الحكومات المركزية وتعزيز سيادتها الإقليمية. ويظهر السودان أوضح مثال على هذا التباين حيث يتخذ دعم كل طرف لقوى عسكرية مختلفة وظيفة تتجاوز السياسة المحلية ليؤثر في رسم ممرات النقل والتموين الممتدة من الساحل إلى الداخل الأفريقي، حتى إن إغلاق قاعدة جوية واحدة في جنوب ليبيا لفترة قصيرة كشف حجم تأثير هذا التنافس في شبكات الإمداد العسكرية والتجارية عبر الإقليم بأسره.
هندستان أمنيتان متوازيتان
مع تراجع مركزية الضمانات الأمنية التقليدية في دول المنطقة اتجه التباين بين الرياض وأبوظبي إلى التمدد خارج الإطار الخليجي نحو شبكة علاقات دولية أوسع، حيث تعمل الرياض على بناء ترتيبات ردع مؤسسية أقرب إلى نماذج الدفاع الجماعي عبر شراكات عسكرية متنامية مع باكستان وإمكانات انضمام تركية تمنح هذا المسار عمقًا عملياتيًا وصناعيًا، فتتبلور منظومة تميل إلى الوضوح الهيكلي وترتكز على التزامات أمنية محددة تحيط بالمجال الجغرافي وتثبّت الاستقرار الإقليمي ضمن إطار هرمي تقوده دولة مركزية. وفي المقابل توسّع أبوظبي شبكة علاقاتها المرنة مع أطراف متعددة تشمل شركات الهاي-تك في إسرائيل والهند ومجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يخلق نمطًا من الشراكات المتحركة التي تجمع الاقتصاد بالأمن وتربط الموانئ والقواعد والبنى الرقمية ضمن فضاء واسع متعدد النقاط. ومن خلال هذين المسارين يظهر في المنطقة نظامان متداخلان في المجال ومتباينان في الفلسفة؛ حيث إن أحدهما يقوم على الضمان العسكري المباشر وضبط المجال الجغرافي، والآخر يقوم على الربط التجاري والتقني وانتشار الحضور عبر عقد لوجستية متفرقة، وهو اختلاف يعكس امتدادًا طبيعيًا للفارق بين اقتصاد مركزي واسع تقوده الدولة واقتصاد شبكي قائم على التوزيع والمرونة.
ونتيجة لهذا التصعيد، ينشأ احتمال تشكّل بيئة إقليمية مجزأة تتقاطع فيها الممرات الاقتصادية والموانئ والمبادرات الدبلوماسية والمنظومات الأمنية المتوازية، فتعمل المنطقة عبر منظومتين تشغيليتين متداخلتين في الجغرافيا ومتباينتين في المنطق، الأمر الذي يرفع احتمالات سوء التقدير ويجعل التنافس يتجاوز نطاق الخليج إلى المجال الأوسع الممتد من شرق المتوسط حتى المحيط الهندي. وبذلك يغدو الخلاف السعودي-الإماراتي أقرب إلى منافسة على صياغة آلية عمل الشرق الأوسط ذاته، أي على الكيفية التي تُدار بها حركته الاقتصادية والأمنية والعسكرية والتجارية في المرحلة المقبلة.